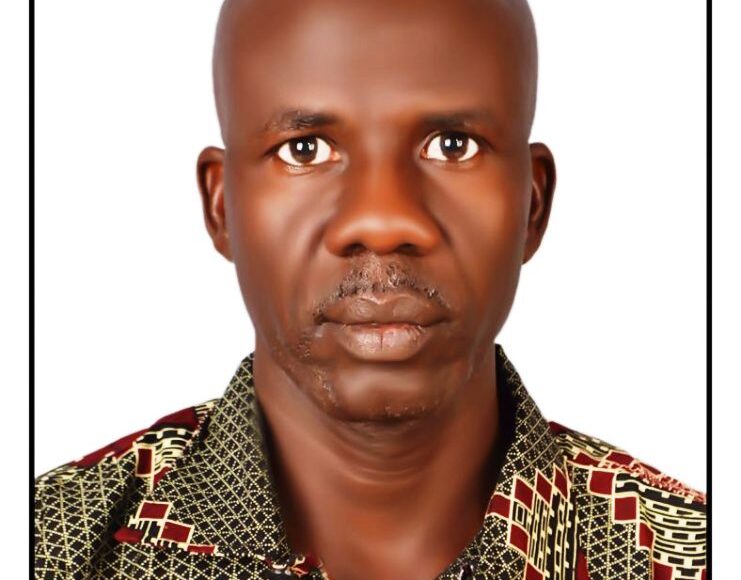
جذور التَّهميش الإقتصادي في السودان: نهب الموارد كان مقدمته ” العبودية” والإقصاء على أساس الهوية.
✍️🏽عادل شالوكا
اطَّلعنا مؤخَّراً على بعض الكتابات التي تناولت قضايا جوهرية تُشكِّل جذور المشكلة السودانية، آخرها كانت حول التَّهميش الإقتصادي في السودان. ولأهمية الأمر رأينا ضرورة مُساهمتنا في هذا الشأن، ولذلك نقول:
إن فهم واقع التهميش الاقتصادي في السودان لا يمكن أن يتم خارج السياق التاريخي والبنيوي الذي تشكَّلت فيه ما يُسمَّى بـ”الدولة السودانية” التي هي غير موجودة الآن وخاصة بعد حرب 15 أبريل 2023. فالمظاهر الحالية من الفقر، ونهب الموارد، والحروب هي ليست أحداث معزولة أو طارئة، بل هي إمتداد لمنظومة راسخة الجذور في التاريخ، كان عمادها “العبودية ” والإقصاء على أساس الهوية. فمنذ القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر نُقل ملايين الأفارقة قسراً عبر المحيط الأطلسي للعمل كعبيد في أوربا والأمريكيتين، حيث تم إختطاف وبيع ملايين الشباب والأفراد القادرين على العمل، مما أدَّى إلى نقص حاد في القوى العاملة المُنتجة في الزراعة والحرف والصناعة المحلية وقد أبطأ ذلك وتيرة التنمية البشرية والإقتصادية في القارة وأحدث فجوات كبيرة في الفئة العُمرية المنتجة وأثَّر ذلك على التركيبة السكانية والقُدرة على التعافي الاقتصادي وخلق إرث من عدم الاستقرار والتبعية الاقتصادية والسياسية التي نشأت بسبب تجارة الرق، وسهَّلت السيطرة الإستعمارية لاحقاً.
يعود التهميش في السودان إلى عصور بعيدة عندما استُخدمت الهوية كأداة للفرز الاجتماعي والاقتصادي. فقد شكّلت تجارة الرقيق واحدة من أولى أدوات النهب المنظم، حيث تم إختطاف الآلاف من أبناء المناطق المهمّشة، خاصة في الجنوب وجبال النوبة والفونج ودارفور، ونُقلوا إلى أسواق النخاسة داخل السودان وخارجه. كانت هذه الممارسات تُمهد لإعادة إنتاج منظومة استغلالية ترى في إنسان الهامش مادةً للعمل القسري أو الحرب، لا شريكًا في الوطن. وهذا ما لا يفهمه الكثير من أبناء الهامش، وخاصة من يعملون مع ما تُسمَّى بـ”القوات المسلحة السودانية”. وقيام تحالف “تأسيس” سيُعيد ترتيب الأوضاع في البلاد بإعادتها إلى منصة التأسيس لبناء وطن يسع الجميع.
في ظل توسع تجارة الرقيق، أستُخدم أبناء الهامش كجنود في الجيوش الإستعمارية، وكعمال في مشاريع البنية التحتية للإمبراطوريات الغربية. هذا الشكل من “التصدير القسري” للموارد البشرية لم يكن سوى أول مراحل نهب الموارد. فبدلاً من تطوير مناطقهم، تم إستخدامهم كأدوات لخدمة المشاريع الإمبريالية، وهو نهج ظل يتكرر بأشكال جديدة حتى بعد خروج المستعمر، حيث تشكَّلت البنية الاجتماعية التاريخية المشوَّهة للدولة السودانية منذ العام 1821 عندما تأسَّست ما يُعرف بالدولة الحديثة بجمع شعوب مُختلفة ثقافياً ومتفاوتة تاريخياً داخل هذا الشكل المركزي للدولة. وقد ظلَّت هذه البنية الاجتماعية المشوَّهة قائمة حتى الآن.
في السودان وخلال الحكم (التركي – المصري) أصبحت تجارة الرقيق واحدة من أهم مصادر الدخل للسلطة الحاكمة والتجار المحليين. تم إستخدام السودان كمصدر رئيسي للعبيد الذين يرسلون إلى مصر والشرق الأوسط، كما استخدم بعضهم للعمل داخل السودان في الزراعة وخدمة الجيش والإدارة. فقد تم التركيز على جمع العبيد أكثر من تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. هذا أدى إلى إهمال البنية الاقتصادية الطبيعية للسودان ونشأت فئة طفيلية من التجار المحليين والموظفين الذين إستفادوا من تجارة الرقيق وراكموا الثروة دون أن يساهموا فعلياً في تنمية الاقتصاد الحقيقي. ويجب الإشارة هنا إن تجارة الرقيق ساهمت في تعميق الإنقسامات العرقية والإقتصادية بين المُكوِّنات الاجتماعية، الأمر الذي كان له أثراً سلبياً لاحقاً بعد خروج المستعمر. فغياب البنية الاقتصادية المتماسكة نتيجة للإعتماد على تجارة البشر أخَّر ظهور إقتصاد وطني حديث في السودان. وهنالك الكثير من البحوث والأدبيات حول الرِق في السودان مثل الدراسة التي أجراها الباحث “هيذر شاركي” بعنوان: (الترف والمكانة وأهمية الرق في شمال السودان خلال القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين) والتي ذكر فيها: (إن الرق كان جزءاً أساسياً من البنية الإقتصادية والإجتماعية في شمال السودان). كما كتب الباحث “مكلوغين” مقالاً بعنوان: (التنمية الإقتصادية وإرث الرِق في جمهورية السودان). حيث تحدَّث فيه كيف إن الرِق ترك أثراً طويل الأمد على الإقتصاد السوداني. كما أشار إلى إن الرِق ساهم في ترسيخ ثقافة إحتقار العمل اليدوي، حيث كان ينظر إلى العمل الزراعي كمهام مُخصَّصة للعبيد مما أدَّى إلى تحدِّيات في تطوير الزراعة الحديثة بعد إلغاء الرق.
ولكن أهم ما كُتب عن تأثيرات الرِق في السودان هو كتاب الدكتور/ أحمد العوض سكنجة بشكل موسَّع عن الرق في السودان بعنوان: (من رقيق إلى عمال: التحرير والعمل في السودان الكولونيالي -Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan) الصادر عن منشورات جامعة تكساس عام 1996. ويُعد هذا العمل من أبرز الدراسات التي تناولت التحوُّل من نظام الرق إلى العمل المأجور خلال الفترة من أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. يُشير “سكنجة” في دراسته إلى إن الرق كان جزءاً من البنية الاقتصادية والإجتماعية في السودان وإنه مع بداية الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) في السودان عام 1898، بدأت الإدارة الإستعمارية في إلغاء نظام الرق تدريجياً، وإستبداله بنظام العمل المأجور. كان هذا التحوُّل ضرورياً لتلبية إحتياجات المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل مشروع الجزيرة والسكك الحديدية والموانيء. تم توظيف الرقيق المعتق كعمال بأجر في هذه المشاريع مما ساهم في تشكيل الطبقة العاملة السودانية الحديثة. ويُلفت “سكنجة” الإنتباه إلى أن الإدارة الإستعمارية إعتمدت على الخلفيات العرقية للعمال في توزيع المهام، حيث تم تخصيص الأعمال الشاقة أو ذات المكانة الاجتماعية المتدنية لفئات مُعيَّنة، مما ساهم في ترسيخ التمييز العرقي في سوق العمل السوداني. ويرَى “سكنجة” أن الرق لم يكن مُجرَّد نظام اقتصادي بل كان أداة للهيمنة الاجتماعية والسياسية، حيث ساهم في ترسيخ الفوارق الطبقية والعرقية، وأثَّر على تشكيل الهوية الوطنية السودانية. ويعتبر كتاب: “من رقيق إلى عمال” مرجعاً هاماً لفهم التحوُّلات الاجتماعية والإقتصادية في السودان خلال الفترة الإستعمارية، ويوفِّر تحليلاً عميقاً لتأثير الرق على تشكيل المجتمع السوداني الحديث.
النهب الذي تعاني منه مناطق الهامش اليوم، سواء في الذهب أو النفط أو الأراضي الزراعية، ليس سوى امتداد لنفس الذهنية الاستعمارية التي نظرت إلى أفريقيا كمخزن للموارد، لا كمساحة لحياة مزدهرة. العقلية التي استعمرت الأمس ما زالت حاضرة في المركز السوداني ولذلك نحن نقول إن ما حدث في السودان ليس ” إستقلال”، بل تسليم وتسلم بين المستعمر الخارجي والمستعمر الداخلي ” نخب المركز”. ، حيث تُدار الدولة بعقلية الجباية لا التنمية ومنذ 1956، ظل الاقتصاد السوداني موجّهًا لا لتحقيق تنمية وطنية شاملة، بل لخدمة مصالح فئة صغيرة من النخب التي تمركزت في الخرطوم ومدن الشمال النيلي. والوسط، فالدولة لم تضع سياسات لتوزيع عادل للثروات، بل أعادت إنتاج “الاقتصاد الإستعماري” الذي يُراكم الثروة في المركز ويُعمّق الفقر في الأطراف.
تتعامل النخب الحاكمة مع الهامش كحقل للنهب لا أكثر من قبل كان النفط في الجنوب، وحالياً الذهب في دارفور، الثروة الحيوانية والغابية في كردفان والفونج ودارفور، والأراضي الزراعية في جنوب كردفان/ جبال النوبة والفونج، كل هذه الموارد تنهب لصالح المركز، دون أي عائد يُذكر للمجتمعات المحلية. يُعاد إنتاج الهيمنة السياسية من خلال السيطرة على الثروة، مما يجعل من الصراع حول الموارد صراعًا وجوديًا بالنسبة لسكان الهامش. ولم يكن تسليح بعض المكونات الاجتماعية ضد أخرى عبثًا، بل سياسة مقصودة، تُعيد إنتاج المنظومة الإستعمارية التي قامت على “فرق تسد”. تم تفقير بعض المجتمعات عمدًا، ثم تحويل شبابها إلى وقود للحروب. هذه الاستراتيجية تحافظ على الهامش في حالة استنزاف دائم، وتحول دون تشكّل جبهة موحدة للمطالبة بالحقوق.
هذه التركيبة البنيوية للدولة السودانية لا يمكن إصلاحها من داخل بنية هذا النظام “المركز المسيطر”. فالعقلية التي بُنيت على العبودية والإقصاء ونهب الثروات لا يمكن أن تنتج عدالة أو وحدة وطنية حقيقية. الخيار الوحيد أمام قوى الهامش وقوى التغيير هو التحرير الكامل من هذا النظام البنيوي الظالم، وبناء سودان جديد على أساس المواطنة المتساوية والعدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات: (سودان حُر علماني، “ديمقراطي تعدُّدي”، لا مركزي، موحَّد طوعياً.


التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.