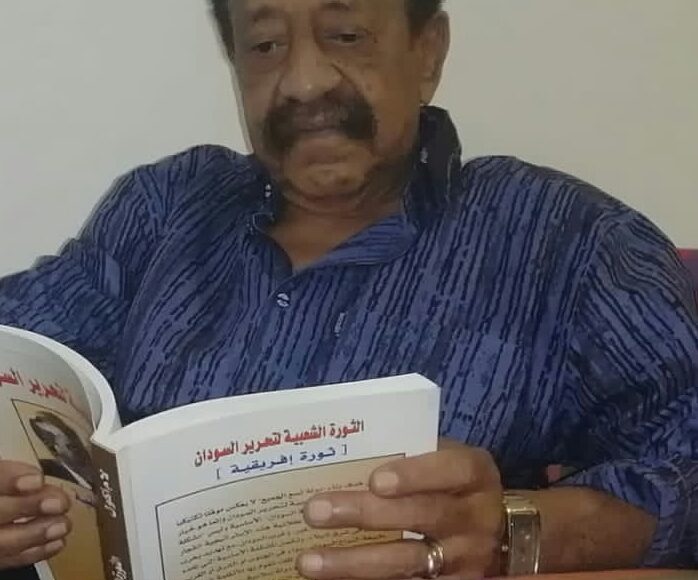
إلَى د.غَازِيّ : اسْتَدَار الزَّمَان كَهَيْئَتِه !
الواثق كمير
إستدار الزمان كهيئته قبل إحدي عشرة عاماً تبادلت فيها رسائل كانت مهمة يومئذ مع الدكتور غازي صلاح الدين، ولعلها ما تزال مهمة اليوم، بل إن تماثل الموضوعات والقضايا بعد كل ذلك الوقت تبدو صادمة ولكن في التاريخ والسياسة لا توجد عبارة فات الآوان (it’s never too late). الدكتور غازي يَومَذاك في قمة قيادة نظام الانقاذ ويجلس علي أهم مواقعها وممسكٌ بأهم ملفاتها، بينما كنت، كما وصفت نفسي في الحوار الذي ابتدرته معه، مواطناً يبصر بعين البصيرة الخطر الذي يحدق بوطنه، قبل أن أكون عضواً في الحركة الشعبية أو رمزاً من رموزها. فقد كان الوضع السياسي حينذاك يشهد تجاذبات حادة واستقطابات متعددة الوجوه والاتجاهات، مما كان يستجدى الشريكين أن يسعيا بجدية لاستحداث منهج وآليات جديدة، وفق مفهوم مشترك “للشراكة”، للتعامل مع بعضهما البعض، من جهة، وبينهما وبين القوى السياسية الأخرى، من جهة أخرى، وذلك بإشراكها في الحوار حول كافة القضايا الوطنية المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
لا أريد المزاودة أن الأحداث أكدت صواب الأطروحة التي دعوت اليها وأهمية الحوار الذي بادرت إليه من شدة وضوحها آنذاك والآن، بقدر ما أريد أن اذكر بالحكمة القديمة: التاريخ يعيد نفسه مرةً علي شكل مأساة وأخرى في هيئة كارثة.
فقد بعثت إلى د. غازي برسالة مفتوحة، نُشرت في العديدِ من الصحف وفي الأسافير، تطرقت فيها إلى القضايا التي ما زالت تؤرق العباد والبلاد تحت عناوين: مأزق التباعد في مواقف الشريكين والاستقطاب السياسي؛ ماذا يريد الشريكان للسودان؟ توحد أم تمزق؟؛ إشراك القوى السياسية والانتقال من التفاوض الثنائي للحوار الوطني؛ وحدة البلاد والتحول الديمقراطي: هل هناك فرصة لمساومة تاريخية؟ (الواثق كمير، وقفة مع النفس: هل نرغب في العيش سويا؟، سودانايل، 10 أغسطس 2009)
على رأس ما طرحته لغازي من مواضيع هو إشكالية العلاقة بين الدين والدولة على خلفية اتفاقية السلام الشامل وعلاقتها العضوية بمفهوم “الوحدة الجاذبة” الذي ابتدعته الاتفاقية. كان جوهر رسالتي أن الوحدة الجاذبة هذه في ظل نموذج “دولة واحدة بنظامين”، لن يُكتبُ لها النجاح طالما تمت مخاطبة ومعالجة قضية “فصل الدين عن الدولة” من خلال هذا المنظور، بل أن نتيجتها الحتمية هي “الفصل بين بلدين”. وربما الأهم، أن تعوِّيل المؤتمر الوطني على أن هذا الفصل سيجري كما تشتهيه نفسه، هكذا سَمْن عَلَى عَسَلٍ، للحفاظ على السلطة في الشمال مُنفرداً، وكأن هذا هو الوضع الطبيعي. ففي كلمة جماهيرية مشهودة، بمدينة القضارف في نهايات عام 2018، قال الرئيس المخلوع أنه “إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الاسلام والشريعة هما المصدر الرئيسي، وتاني ما في دغمسة”.
ختمت رسالتي لدكتور غازي في هذ الموضوع بأن نموذج الدولة الواحدة “بنظامين قانونيين” (والذي هو بمثابة بروفة “لدولتين بنظامين”) يمثل وضعاً يقِّرُ الانفصال نظرياً، لا ينفع معه صنع “الشربات من الفسيخ”، ولا ينتظر إلا الاستفتاء ليصير واقعاً (وحدس ما حدس). إن أمر العلاقة بين الدين والدولة يقع في صلب قضية الوحدة الطوعية، ولذلك يبقى الاشتباك حول أعراضها فقط، دون إرجاعه لأصله، مجرد دخان ترقد تحته نار، تصطلي بها البلاد الآن في ظرف انتقالي شاق وغير مسبوق. فإن كان د. غازي يدعو للحوار هذه المرة، فعليه أن يخرج بمبادرة واضحة القسمات يعرضها على القوى السياسية والمجتمعية للتداول بشأنها والتفاعل معها من أجل الانتقال ببلادنا إلى رِحاب دولة المواطنة الحقيقية، التي تكفلُ الحقوق المتساوية والمساواة أمام القانون.
رسالة مفتوحة
وقفة مع النفس: هل نرغب في العيش سويا؟
الواثق كمير
تونس، أغسطس 2009
عزيزي د. غازي
سلامات من تونس الخضراء
تهدف رسالتي هذه إلى فتح حوار حقيقي حول مواضيع مؤرقة تستحق النقاش وجديرة بالتأمل العميق والتفكير بعيد النظر، وتطرح قضايا متداخلة ووثيقة الصلة بما نمر به من ظروف صعبة في طريق طويل وشاق نحو بناء الدولة السودانية الحديثة! وهذه القضايا، في ظني، هي تعبير عن وتجسيد للأزمة السياسة العامة وما يحيط بها من مآزق تبعث على القلق في ما يخص إمكانية العبور نحو غد أفضل على خارطة طريق التحول نحو بناء دولة المواطنة السودانية القوية التي نفخر بها ونعتز بالانتماء لها جميعا إسلاميين كنا أم علمانيين، شماليين أو جنوبيين، وبغض النظر عن “أصلنا وفصلنا” أو لوننا “أصفر” كان، أم “أخضر” أم “أسود”!
لم يكن اختياري لك لمثل هذا التفاعل عشوائيا، إنما مقصودا لأسباب موضوعية، وأيضا ذاتية, فموضوعيا، أنت تتبوأ مواقع قيادية سياسية في الحزب الحاكم ورئيس لكتلته النيابية في المجلس الوطني، والمكلف بمتابعة ملف دارفور والعلاقات السودانية الأمريكية، ومستشار لرئيس الدولة على المستوى التنفيذي. وذاتيا، لي معك تجربة في اللقاء الوحيد الذي جمعنا بمكتبك بالخرطوم، فقد استمعت لي جيدا وتوصلنا إلى فهم مشترك حول عدد من القضايا المتصلة بحرية التعبير والنشر وإعلاء قيم الحوار. وأنا من جانبي لا أخاطبك بصفتي عضو في مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية أو قيادي بها (كما يحلو للبعض) أو مروج لسودان جديد، فحسب، بل كسوداني أتاح له وطنه فرصة للتعليم العالي وقدر من المهارة والخبرة تفرض على أن أشارك في صنع مستقبله وأن أعبر عن خوفي وقلقي على مصيره وبلدنا يمر بأدق ظرف وأحرج الأوقات وبأهم نقطة تحول في تاريخيه ليكون أو لا يكون! فوحدة السودان، سواء على أسس جديدة أو قديمة، أضحت مهددة وفى خطر عظيم أكثر من أي وقت مضى، بصورة لم يعد يجدي معها نفعا تكرارنا ل”الوحدة الجاذبة”، في غياب تام للحوار الجاد حول المعنى الحقيقي لهذه العبارة!
إشكالية الدين والدولة
الجدل حول القانون الجنائي: وميض تحت الرماد!
ردود عنيفة (بما فيها ردك الغاضب) صاحبت كلمة ياسر عرمان في المجلس الوطني- رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية- حول العقوبات الحدية في القانون الجنائي وتطبيقها على غير المسلمين، لكنها امتدت خارج البرلمان “الانتقالي” ليستغلها الخصوم السياسيون في قهر الرأي الآخر وإسكات صوته لحد التحريض بالقتل، ووصلت ذروتها بإصدار ما يسمى “هيئة علماء السودان” لفتوى تحريضية وتكفيرية في حق نائب الأمين العام للحزب الشريك في الحكم، (بل، ولاحقا، الشروع في تنفيذها بوضع متفجرات أمام مكتبه بدار الحركة الشعبية بأركويت). وفى ظل هذا الغبار الكثيف، جاء بيانك الايضاحى المقتضب (فليكن الخلاف ولتبق حرية التعبير مبدءا يحترمه الجميع) ليخفف مما خلفته الواقعة من احتقان. ومع نجاح بيانك في درء الشبهات وتهدئه النفوس، ومع اتفاقي معك حول الاختلاف في فلسفة التشريع ، إلا أن موضوع الخلاف في حد ذاته يظل سياسيا من الدرجة الأولى ويبقى الاشتباك حول أعراضه فقط، دون إرجاعه لأصله، مجرد دخان ترقد تحته نار! فهو يتصل مباشرة بمسألة فرص تحقيق خيار الوحدة المفترض نظريا أن يعمل من أجلها الشريكان وكافة القوى السياسية، خاصة في الشمال. من جانب آخر، فاني أرى أن إثارة الموضوع يوفر فرصة لفتح حوار جاد وأمين حول العلاقة بين الدين والدولة التي تقع في صلب قضية الوحدة الطوعية.
لاشك أنه إن شعر الجنوبيون، وخصوصا غير المسلمين، واقتنعوا تماما بإمكانية المنافسة بمطلق الحرية وعلى قدم المساواة، على كل المواقع السيادية العليا في البلاد وبدون أي قيود دستورية (كما يقرره “نظريا” الدستور الانتقالي القائم)، أفلا يمثل الإصرار على تطبيق قوانين ذات أصول دينية في شمال السودان عائقاً ونوعاً من الموانع المؤسسية والثقافية والاجتماعية، الذي يصبح معه الحق الدستوري لغير المسلمين في المنافسة على هذه المواقع، خصوصاً منصب رئيس الجمهورية، مجرد مظهر خادع وأمنية طيبة؟ حتى، ولو تمكن مرشح من غير المسلمين (نظريا أيضا) من الفوز في الانتخابات بمقعد الرئاسة، فهل من المستساغ سياسيا له أن يكون على رأس حكم بالبلاد يطبق قوانين دينيه على “المواطنين” في جزء من البلاد، بينما يخضع فيه “المواطنين” لقوانين مدنية في جزء آخر؟ وبنفس القدر، ألا يتناقض إخضاع غير المسلمين من الجنوبيين إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الشمال، بينما يتم تطبيق قوانين مدنية في الجنوب (حتى على غير المسلمين) مع مبدأ مساواة مواطني البلد الواحد أمام القانون؟ وفوق ذلك كله، ألا يمثل هذا التمييز، القائم على دين المواطن، انتقاصاً بيّنا لحقوق المواطنة وإخلالاً بتكامل عناصر “الوحدة على أسس جديدة”، والتي لا تقبل الاجتزاء أو الاختزال؟ فهل سيصوت الجنوبيون لصالح وحدة تقوم على استدامة الترتيبات الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل التي تجمع بين نظامين تشريعيين مختلفين، بينما تتيح لهم نفس الاتفاقية خيار إقامة دولتهم المستقلة بقوانينها المدنية؟ وما هو المنطق الذي سيدفع غير المسلمين، أو الجنوبيين عموماً، للقبول طواعية باحتمال تعرضهم، حتى ولو نظرياً، لعقوبة الجلد أو بتر الأيادي؟ وما هو المغري في هذا النوع من الوحدة الذي يحثهم على دفع مثل هذا الثمن، وهم يملكون خياراً آخرا؟ وما الذي يدعو الجنوبي (أو غير المسلمين عموما) للبقاء والعيش في “وطن” لا يوفر له (لهم) حقوق المواطنة الكاملة وبدون انتقاص منها؟
إذن، لعلك تتفق معي على عدد من الفرضيات الأساسية:
i. أن التعدد الديني في السودان يقتضي أن يعالج موضوع الدين والدولة بصورة تأخذ في الاعتبار ذلك التعدد وخصوصية التنوع السوداني، دون النقل الحرفي من تجارب الآخرين، بل الاستفادة واستخلاص الدروس منها.
ii. احتل موضوع الدين والسياسة، أو الدين والدولة، حيزاً كبيراً في الجدل السياسي منذ الستينيات، كما أنه في جانب منه، كان امتداداً لجدل أوسع على نطاق الأمة الإسلامية كلها حول الحفاظ على الهوية في سياق عالم تعددي. وهكذا، فان المطالبة بفصل الدين عن الدولة لم تأت بها الحركة الشعبية التي تأسست في عام 1983، ولا قطاعها الشمالي، أو الشماليين من قياداتها، الذين تلصق بهم فرية “الإلحاد” وكل أنواع الرزايا، ويتم اتهامهم بموالاة الحزب الشيوعي وتصويرهم كغواصاته داخل الحركة. ولكن، لا ينفى هذا التجني على النفر الشمالي موقف الحركة المبدئي من العلاقة بين الدين والدولة كأهم ركيزة لمشروع السودان الجديد.
iii. ظلت مسألة الدين والدولة على قمة أجندة الجولات المتعددة للتفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، منذ أول لقاء لهما في أغسطس1989، من ناحية، وموضوعاً ساخناً للحوار بين الحركة الشعبية وحلفائها في التجمع الوطني منذ انضمام الحركة للتجمع في 1990، ومن بينها أحزاب ذات قاعدة دينية وتوجه إسلامي.
iv. إن الفشل في التوصل إلى اتفاق على إقامة دولة ديمقراطية مدنية يفصل دستورها بين الدين والدولة وفقا لإعلان الإيقاد للمبادئ هو الذي مهد الطريق لتبني ترتيبات “الدولة الواحدة بنظامين” في ماشاكوس في 2002، ولاحقا تضمينها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي في عام 2005.
v. حدث اختراق هام في هذا الشأن له أثر إيجابي على وحدة البلاد تمثل في قرار التجمع الوطني حول “الدين والدولة” الذي تبناه مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية في عام 1995، وهو بمثابة موقف متقدم ومتطور للقرار الذي أصدره التجمع حول نفس الموضوع في نيروبي عام 1993. ورغماً عن أن “إعلان أسمرا” أكد على حق تقرير المصير للجنوب، إلا أن القرار الخاص بالعلاقة بين الدين والدولة، تم تثبيته على مبدأ عدم استغلال الدين في السياسة، وذلك بإقرار العديد من التدابير الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة، بما في ذلك الاحتكام للقضاء، وتطابق كل القوانين مع المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتقضي ببطلان أي قانون يصدر مخالفاً لذلك وتعتبره غير دستوري.
لماذا نخلط المواضع فنفرق بين شعبنا ونحصد الشقاق؟
وبالتالي، فإن تم الاعتراف بأن وحدة السودان يتهددها الخطر، فما الذي يمنع المؤتمر الوطني من التوصل إلى اختراق آخر في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان؟ فعلى المؤتمر الوطني كحزب جاء للسلطة “كجبهة إسلامية”، تدعو إلى تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الإسلامي في كل السودان، وظل يمسك بمفاصل الدولة ويقود مؤسساتها، يتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية الحفاظ على وحدة البلاد بعد احتكار كامل للسلطة لأكثر من عقد ونصف من الزمان (1989-2005). كما سيكون صاحب الحصة الأكبر من النتائج إن تحققت الوحدة أو وقع الانفصال.
أفلا يمكن أن يطور المؤتمر الوطني موقفه من قضية العلاقة بين الدين والدولة بما يسمح بالتعايش السلمي بين مختلف الأديان في إطار دولة ديمقراطية تكفل حقوق المواطنة للجميع؟ فالحزب الحاكم نفسه تعرض للتحول والتغيير من الأخوان المسلمون” إلى “جبهة الميثاق” إلى “الجبهة الإسلامية القومية”، ومن ثم إلى المؤتمر الوطني”! فقوانين الشريعة التي طبقها نميرى في سياق نظام شمولي، وشكلت أساسا لبرنامج الجبهة الانتخابي، لم ينفعها أو يخدمها في كسب أصوات الناخبين في انتخابات 1986، رغما عن رفضها القاطع وشنها الحرب على الداعين لإلغائها أو تعديلها أو حتى “تجميدها”، ولولا دوائر الخريجين (المثيرة للجدل) لما احتلت المركز الثالث من ناحية عدد الدوائر الانتخابية التي فازت بها! ومن ناحية أخرى، ألا يمكن للمؤتمر الوطني الاستهداء بتجارب الآخرين من الدول الإسلامية (مصر، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، سنغافورا) في الاتفاق على صيغة تكفل المساواة في حقوق المواطنة، وفي الوقوف أمام القضاء المدني، بغض النظر عن المعتقد الديني للفرد؟ لقد نجحت، على سبيل المثال، الجارة مصر في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنة، وتطلعات الأغلبية المسلمة في البلاد. فالتعديلات الدستورية التي أجازها مجلس الشعب المصري في مارس 2007، أبقت على المادة (2) المثيرة للجدل في الدستور المصري، والتي تجعل من “مبادئ التشريع الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع”. وبرغم ما أثارته هذه المادة من شكوك وتخوف وسط الأقباط المصريين، إلا أنها وجدت قبولاً لدى قطاعات واسعة من القوى السياسية المصرية، كما لم تعترض عليها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، طالما ظل كل المصريين، سواء كانوا مسلمين أم أقباطاً، يخضعون لنفس القوانين المدنية الموحدة للبلاد، فيما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. وفى لبنان، حيث تقوم السياسة على المحاصصة الدينية-الطائفية، يحتكم كل المواطنين اللبنانيين إلى القانون المدني، فيما عدا قضايا الأحوال الشخصية. وهاهو حزب إسلامى عتيق، حزب العدالة والتنمية التركي، يكتسح الانتخابات التركية الأخيرة، وفق دستور يفصل بين الدين والدولة وجيش مكلف دستوريا بإنفاذ العلمانية، بدون أن يتشكك أحد في، أو ينتقص من إسلاميته!
وهذا كله لا يعنى توقف الحوار والجدل حول موقع الدين من الدولة والسياسة في كل هذه البلدان من أجل الإعلاء من قيمة المواطنة، بغض النظر عن الانتماء الديني للمواطن طالما كانت حرية العبادة والتدين وإقامة الشعائر مكفولة للجميع! فلماذا نخلط المواضيع فنفرق بين شعبنا ونقسم الناس ونزرع الشقاق بينهم، فلا نحصد إلا التشرذم والتفكك والانهيار الشامل.
أم هل يظن المؤتمر الوطني إن إخلاء الساحة السياسية في شمال السودان من الحركة الشعبية (أو الشماليين بداخلها) أو الجنوبيين، سيحسم الصراع حول موضوع القوانين الدينية ويغلق ملف العلاقة بين الدين والدولة نهائيا؟ إن كان كذلك، فمثل هذا الاعتقاد يفتقر إلى بعد النظر والواقعية. فالجدل حول قضية الدين والدولة، كما أسلفنا ذكره، كان مسرحه شمال السودان، منذ الستينات من القرن الماضي، وليس جنوبه. فمن جانب، لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم، فالسيد الصادق المهدي، على وجه المثال، دائما ما يذكرنا بضرورة التفريق بين “رؤية المؤتمر الوطني” و”رؤية أغلبية مسلمي الشمال” لهذه القوانين، بينما وافق مولانا محمد عثمان الميرغني على تجميدها في إطار اتفاقية “سلام السودان” في 1988. ومن جانب آخر، هناك أعداد مقدرة من غير المسلمين، سواء كانوا مسيحيين أم من أصحاب كريم المعتقدات الأفريقية، في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولا أحتاج إلى التشديد على أن هذه المناطق مأهولة بقواعد الحركة الشعبية وتمثل جزءا من مشروع السودان الجديد الذي يشكل فصل الدين عن الدولة أحد دعائمه الأساسية. بلا شكك أن موضوع الدين والدولة ستكون له تداعياته، وسيلقى بظلاله على عملية “المشورة الشعبية” في هاتين المنطقتين. فالتعدد الديني في شمال السودان الجغرافي لا يقف عند هذا الحد، فأين مكان قبط السودان في هذه المعادلة وهم أصحاب حق أصيل فيه؟ وهل نسينا دارفور؟ فحركة تحرير السودان، على الأقل جناح عبد الواحد محمد نور، تدعو بقوة لفصل الدين والدولة ويجاهر زعيمها ب”العلمانية”، وإن تعمد البعض التقليل من أمره والتبخيس من شأنه. فهكذا، على المؤتمر الوطني أن لا يسعد كثيرا بتجنب الحركة الشعبية أو الجنوبيين إثارة هذه القضية في هذه المرحلة، التي ستظل محورا للصراع وعائقا للوحدة حتى في حدود الشمال الجغرافي.
إن الدعوة لفصل الدين عن الدولة لا يعنى إطلاقا، كما يسئ البعض تفسيره أو يتناوله خطأ، الإلحاد أو إبعاد الدين (الإسلام) عن الحياة أو المجتمع، ولو بأي شكل من الأشكال، فالدين جزء أصيل من الإنسانية. كما لا يفرض هذا الفصل على المسلم أو غيره أن يهجر نفسه أو ينخلع عن ثقافته. بل المقصود هو أن تبقى الدولة محايدة تماما تجاه مواطنيها على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، وأن لا يستخدم الدين كأساس للقوانين التي يحتكم إليها جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم، إلا بالطبع فيما يتصل بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية. فبدون حاجة لفرضها قسرا وبسلطة مؤسسات الدولة، فالشريعة أصلا تلعب دورا رئيسيا في تطوير وتشكيل القيم والمعايير الأخلاقية والتي تنعكس على التشريعات والسياسات العامة عن طريق العملية السياسية الديمقراطية. فالدولة مؤسسة سياسية اجتماعية، يديرها سياسيون من مختلف الأديان والمذاهب، وليست لها سلطات دينية، مما يجعل المحصلة النهائية لتطبيق القوانين الدينية خاضعة للإرادة السياسية للدولة ومصدرا لشرعية النخب الحاكمة باسم الإسلام.
بهذا الفهم أيضا، لا يعنى فصل الدين عن الدولة استبعاد الإسلام من صياغة التشريعات والسياسات العامة، والتي بالضرورة لا بد من عكسها لمعتقدات وقيم المواطنين الدينية، شريطة أن لا يكون ذلك باسم دين بعينه في بلد متعدد الديانات والمعتقدات. فذلك يعنى صراحة تفضيلا لوجهات نظر من يسيطرون على سلطة الدولة فقطـ مع إقصاء أديان ومعتقدات المواطنين الآخرين. وبالتالي، فالمقصود هو الفصل “المؤسسي” بين الدين والدولة، دون أن يعنى ذلك فصل الدين عن السياسة، والذي قد يكون ضروريا ومرغوبا فيه، بل ومنسجما مع واقع المجتمع الذي نشأنا ونعيش فيه. فغالبية أحزابنا السياسية تستند على قواعد دينية وتكوينات طائفية ومذهبية. فحتى القوى السياسة، الموسومة ب”العلمانية” كالحركة الشعبية، مثلا، تثابر على خلق وتطوير العلاقات مع القيادات الدينية المختلفة والزعامات الطائفية والطرق الصوفية. ألم نشاهد فاقان أموم يرتدى الجلباب الأخضر ويطوق عنقه بسبحة “اللالوب” ويتمايل مع دقات “النوبة”، في حضرة الشيخ أزرق طيبة! إضافة إلى أنه من المستحيل أن لا تؤثر القيم الدينية للمسلمين على السلوك والفعل السياسي سواء للمسئولين في الدولة أو المواطنين العاديين.
فهكذا، المسألة في جوهرها ليست بجدل فقهي أو ديني حول دولة “دينية-إسلامية” في مقابل أخرى “علمانية-ملحدة”، بل هي قضية سياسية تتلخص في كيفية حفظ حقوق المواطنة وتأسيس الدولة ودستورها على هذا الأساس، وهو ما قامت عليها مبادئ الدستور الانتقالي! ولكن يظل نموذج “الدولة بنظامين” وضعا انتقاليا أفرزته مباحثات السلام حول قضية الدين والدولة (أو المواطنة) بين طرفي الاتفاقية. فهو الموضوع الوحيد الذي تعثر التوافق عليه فتواصى الطرفان، بشهادة الوسطاء على “ترحيله” وتأجيل البت فيه خلال الفترة الانتقالية، وأفضى إلى استحداث وتقديم عبارة “الوحدة الجاذبة” كمخرج بعد الاستعصاء الذي وصلت إليه مفاوضات نيفاشا في هذه القضية. الآن، والجميع مقبل على انتخابات عامة واستفتاء على تقرير مصير الجنوب، فالفرصة سانحة للانتقال من (التفاوض) إلى (الحوار) بشأنه. فهذان مفهومان مختلفان!
إذن، العلاقة بين الدين والدولة هي التي أصلا وقفت حاجزا وحالت دون وصول مباحثات السلام إلى اتفاق على دولة موحدة “بنظام تشريعي واحد” وفقا لأي من المشروعين المقدمان من طرفي التفاوض: الدولة الإسلامية في مقابل الدولة العلمانية/ المدنية. ومع أن نموذج الدولة الواحدة “بنظامين قانونيين” (والذي هو بمثابة بروفة “لدولتين بنظامين”) يمثل وضعا يقر الانفصال نظريا، لا ينفع معه صنع “الشربات من الفسيخ”، ولا ينتظر إلا الاستفتاء ليصير واقعا!، إلا أنه يمثل وضعا فرضه منطق المفاوضات.
عزيزي د. غازي
أطلت وأسهبت علنا نصل لأرضية مشتركة تسمح بالحوار من أجل بقاء وطننا موحد ينتمي له ويفخر به جميع السودانيين!
ولك شكري وتقديري

